في الأسابيع التي سبقتْ فقدانه الرشد، تحدّث نيتشه عن «ميعاد للأسئلة والمسائل». وقد استخدمَ فعلاً تعبير «ميعاد» إذ أراد القول إنّه أمضى العمر يجري لاستقبال العالم والعالم يجري نحوَه. وكان هذا الانجذابُ المزدوج، هذه الحركة، أمراً جوهريّاً بالنسبة إليه. إنّ روح نيتشه جزيلة الكرَم جعلتْ منه نقطةَ التقاءٍ لقوى كَونيّة، للتيّارات الاجتماعية في عصره ولأفكارٍ بدا غالباً أنّه يلتقطها أكثر مما يُنتجها. وهذا الكرمُ شكْل من أشكال الحب.
لم يمنحنا نيتشه حبّ «الكائن» بطريقةٍ جذريّة وحسب، منحَنا حبَّ أشياءٍ عاديّة أيضاً، أيْ حبّ كل ما كان يلامسُ روحَه والقلب. لهذا لم تكن له منظومة فلسفية متكاملة، وما من نواة صلبة في فكره، وإنّما متواليات أساسيّة من نتاج الحدْس.
نيتشه والحبّ الصوفيّ
قد يدعو للاستغراب أن يذكّرني نيتشه بالحلّاج، ذلك أنّ صوفيّة الأخير الإسلامية قد تبدو على النقيض من أفكار نيتشه. لكن الفيلسوف الألمانيّ والصوفيّ الفارسيّ في القرن العاشر كليهما قد دفع بطاقته الإبداعيّة إلى أقصى مداها، باذلاً التضحّيات ثمناً لالتزاماته الجذريّة. يقول الحلّاج: «أنا الحقُّ». ويؤكّد «شاهدتُ الله بعينَي القلب فسألتُه «مَن أنت؟» فأجابني «أنا أنت!»». وفي «أناشيد جامحة إلى ديونيسيوس»، يشير نيتشه إلى نفسه بطريقةٍ غير مباشرة على أنّه الرجلُ الذي يعلن «أنا الحقيقة». والاثنان استهلكا الكلامَ وهما يبحثان عن المطلَق. والمطلق هو الله بالنسبة لدى الواحد وتَحوُّل القيَم (وانفجارها) لدى الثاني. الحبّ هو المبدأ الأسّ الذي تحكّم بالحلّاج، أي الرغبة في بلوغ نار الإرادة الإلهيّة واقتحامها حتى الموت. هكذا استقبل الحلاج الحكمَ بإعدامه بالتعذيب والصَلب بما هو الثمن لإشباع شغفه. مثله اختار نيتشه لنفسه العزلة المطلقةَ التي دفعتْه إلى الجنون بما هي الثمن لنيل حريّته في مواصلة سعيه.
والحال أنّ الالتزام العميق لنيتشه بفكره الثوريّ والرؤيويّ ضاعفَ من حبّه لـ«كوزيما». في كتاباته الأخيرة، إبّان سنوات الاختلال العقليّ، عبّر عن حقده ضدّ جميع من قابل من بشَرٍ باستثناء كوزيما ڤاغنر، ويبدو أنّ آخر ما صدرَ عنه وهو في حالة صحوٍ بِطاقةٌ أرسلَها إليها يقول فيها (وهو في حالة يأس، في أقلّ تقدير) «آريادن، إنّي احبك! ديانيسيوس»*.
يصعب التغافل عن الحبّ الجارف الذي غذّى طاقة الصوفيّين من جميع الديانات. حتى غيرُ المؤمنين يمكن أن يدهشوا، مثلاً، لكتابات كبار شيوخ الصوفيّة، ولأشعارهم، ولأسئلتهم الفلسفيّة أو للغنائيّة العميقة التي تمتزجُ عندهم برغبةٍ إنسانيّة حارقة للاتصال بالألوهة.
تشهد النصوص الصوفيّة، أكثر من أيّ وسيلة تعبيرٍ أخرى، على تجربة الوحدة العميقة للحب. فمع أنّه يمكن التمييز بين مختلف وسائل التعبير عن الحب، إلّا أنها تصدر جميعاً عن مصدرٍ واحد. فمثلما الطاقةُ الكهربائيّة تتوزّع على شحنات مختلفةٍ (ومتناقضة) كذلك الحبّ يتعلّق بالطبيعة وبالطاقة الجنسيّة وبالروابط الأسريّة وبالعِلم، إلخ. انّه يولَد من نواةٍ واحدةٍ منبثّةٍ في ذهن المرء وفي شجرةِ نَسَبِه، كما في تلك المدارات الغامضة التي نسمّيها «عالم الغيب».
على الرغم من أنّ المعتقدَ الشعبيّ يرى عادةً في الحبّ ضروباً من الغنائية والشغف، لا يجوز أنْ نختزله إلى هذا وذاك. أتذكّر، في حالتي الشخصيّة، شغفَين لا يرتبطان بكائناتٍ بشريّة لكنّهما كانا جوهريّين بالنسبة لي.
بين بحرٍ وجبل
خلال نشأتي في بيروت في سنوات الثلاثين، كنتُ واحدةً من أطفالٍ نادرين قيّض لهم أنْ يؤخذوا إلى شاطئ البحر ليسبحوا. لم يكن للمدينة حينَها شواطئُ مجهّزة كما تلك التي يفيد منها الناسُ في أيّامنا هذه. كان البحر يصلُ مباشرةً إلى حدود المدينة، وصخورٌ تتوسّطُها بُرَكُ ماءٍ صغيرةٌ لا تبعُد أكثرَ من بضع مئاتٍ من الأمتار عن بيتنا. تجلسُ أمّي على واحدةٍ من تلك الصخور وتتركُني ألعبُ في الماء. من قَبيل الأمان، تربطُ خيطاً أو حبلاً حول صدري، تقيّدني به وتتشبّثُ به بعناية. هكذا نما عندي، منذ سنٍّ مبكّرة جدّاً، ردُّ فعلٍ حسّيّ تجاه البحر، انبهارٌ به، بل تولّدتْ رغبةٌ أعيشُها بما هي رغبةٌ سرّيّة. وكان ذلك الإحساسُ يسحرُني ويعزلُني. ولم يبارحْني قّطّ.
بعد عشراتٍ من السنين، سكنتُ كاليفورنيا. خلال سنواتي الاولى هناك، ساورني شعور عميق بالاقتلاع. كنت أعيش في شمال سان فرانسيسكو على الضفة الأخرى من «جسر البوابة الحديدية» فتعلّقت بجَبَل «تامالباييس» المشرف على المنطقة. بدأت أتديّر قياسا له، وأهتدي بحضوره البعيد. صار الجبل رفيقي. ولما بدأتُ الرسم، رسمت الجبل صوّرته. ثم انتقلت الى «ساوسَليتو»، وسكنت بيتاً يغشى نوافذَه منظرُ الجبل. خلال سنوات اقتصر مدى بصري على مشاهدة هذا الجبل إلى حدّ أنّي لم أعد افكّر بأيّ شيءٍ غيرِه: أراقب تحوّلاتِه المتواصلة، حتى صار شاغلي الشاغل. حتى أني ألّفت كتاباً عنه لكي أتبيّنه بوضوح - لكنّ التجربة فاضتْ عن قدرة الكتابة على التعبير عنها. كنتُ كمَن أدمنَ المخدّرات.
صحيح أنّني كنتُ أرتاد نَوادي الجاز الصغيرة وأتنزّهُ جهةَ المحيط، وأزورُ وادي غابة «يوزيميت» بالسيارة، وأتنشّقُ هواءَ كاليفورنيا ملءَ رئتيّ. لكنّ هذا كان كلّ ما في الأمر. نسيتُ كل إمكانيّةٍ لعَيشِ حياةٍ شخصيّة أخرى! لست نادمةً على ذلك. بالعكس، كانت تلك سنوات البدائع.
يمكن القولُ إنّ حبّ شجرةٍ أو حتى حبَّ الطبيعة أمرٌ رحيم. لكنّ الحبّ ليس بالأمر الرحيم أبداً. يمكنُه أن يملأ كيانّك برمّتِه، وهو فاعلٌ ذلك. ما نسمّيه «طبيعة» ينطوي على أجوبةٍ لا متناهية، تنطوي على الاستغلال والمجازفة والثورة في حياتنا. قد يقودُك ذلك إلى جبال «هِمالايا»، أو يرقى بك إلى حافّة بركان، أو يرميكَ في هاوية، كما قد يقودُك الى مختبرات. الحبّ قابلٌ لأنْ يعرّفَكَ إلى خفايا شخصيّتك. والحبّ يُلهمُ الفنّانينَ والشعراء والفلاسفة. والحبّ يفتح لك المسالكَ لاكتناه التّسامي.
يتصرّفُ المزيدُ والمزيدُ من الناس وكأنّهم يجهلون الطبيعة، لأنّهم لا يحبّونَها بل إنّهم يتصرّفون كما لو أنّهم يكرهونها. ولولا ذلك لما أصابتْنا الكارثة البيئيّة الحاليّة. هؤلاء الناسُ عاجزون عن إدراك الجوابِ الذي وجّهه الزعيمُ الهنديُّ جوزيف للمستوطنين الأميركيين عندما حاولوا إجبارَ الهنود على فلاحةِ الأرض، قال: «كيف يمكنني أن أبقرَ بطن أمّي بواسطة محراث؟» ولم يكن هذا عندَه من قَبيل الاستعارة. الأرض هي الأمّ في نهاية المطاف. إنّها مانحةُ الحياة. وهذا ما يقودُنا إلى الآتي: الديانات تقولُ الشيءَ نفسَه على طريقتها الخاصّة، والعلومُ كذلك، ومثلهما الحسّ الشعبي. لذلك فنحن لا نحبّ إلّا أمَّنا الأولى، أمّنا الأصليّة. لكننا نهجرها. قد وضعناها خلفَنا وصعدْنا إلى القمر.
bid25_noun_wal_qalam_etel_adnan.jpg
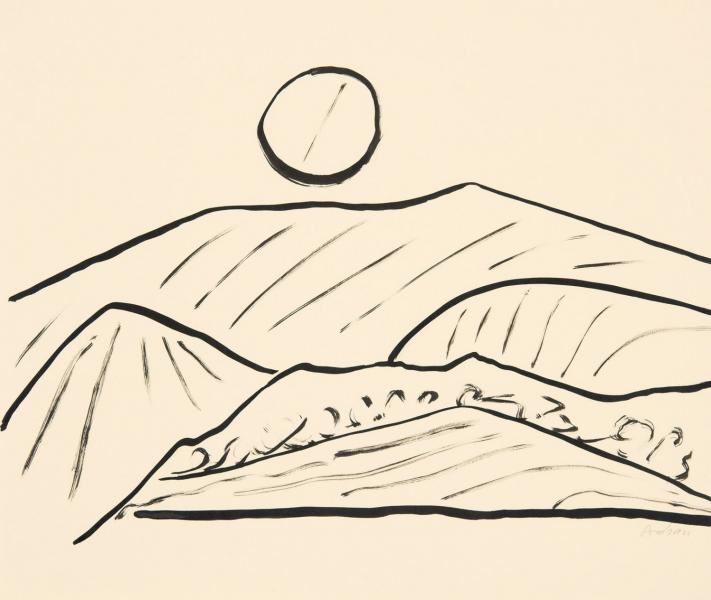
من دون عنوان، إتيل عدنان، ٢٠١٤، زيت على قماش
«الحبّ مُزعج»
على الصعيد الرمزيّ، الحقّ يُقال إنّنا فقدْنا كلّ اهتمامٍ بكوكبنا البدويّ. تتعلّق الأبحاث الأكثرُ تقدماً على الصعيد العالميّ الآن إما بالجزيئات الصغيرة (ميدان الذرّة) وإمّا بالشاسع اللامتناهي. وها هو الجنسُ البشريّ يدرس احتمالات السكَن في كواكبَ أخرى. إنّ التكنولوجيا موضوعةٌ كليّاً في خدمة العلم المجرّد وعواقبها تَفوق التصوّر. باتَ كوكبُنا الأرضيُّ قصةً قديمة. إنّه البيتُ الذي نهجرُه. في الحقيقة، نحن لا نحبّه. ولعلّنا نظنّ أنّنا لم نعُدْ بحاجةٍ إليه. ذلك أنّ ثمنَ الحبّ الذي يمكنُه أنْ ينقذه قد يصلُ إلى مستوىً يكاد أن يكون مستحيلاً. ذلك يتطلّب أنْ نغيّرَ جذريّاً من أنماط حياتنا، وأنْ نتخلّى عن قسمٍ كبيرٍ من راحتنا وألعابنا وأدواتنا الإلكترونيّة، وفوق ذلك كلِّه، أنْ نتخلّى عن أساطيرنا السياسيّة والدينيّة. يتعيّن علينا مِن ثَمّ أنْ نخلقَ عالَماً جديداً (لكنّه ليس هو «أفضل العوالم»!) ونحن لسنا مستعدّين لأنْ نفعلَ ذلك. لذلك ها نحن سائرون إلى التهلكة بكلّ بساطة.
نستطيع أيضاً أن نستحضرَ كلّ المناضلين السياسيّين، من أبطالِ حركاتِ التحرّر، والمدافعين الحقيقيّين عن حقوق الإنسان، والثوّار... وبعد ذلك، ما الذي نستطيعُ أنْ نفعلَه بهم؟ نتركُهم يموتون في المصحّات العقليّة، في السجون، في المنافي... وحدَهم الذين يعبُدون السلطةَ، المالَ، الحربَ والجريمةَ المنظّمةَ هم الذين يتحرّكون في رابعة النور. إنّنا في لحظةٍ من التاريخ حيث الديمقراطيّاتُ الغربيّةُ، التي كانت تعتبرُ نفسَها طليعةَ الحرّيّة، تشهد تفكُّكَ قيَمها، والتشكيكَ بحرّيّاتها، وهُجرانِ نزعتِها الإنسانيّة، وكلُّ هذا لأنّ اكتشافَها لضعفِ قُدْرتِها على الساحة الدوليّة يولّدُ لديها ذعراً حقيقيّاً. فما العملُ، إذاً؟
بإلحاحٍ شديدٍ، ينبغي أن نعثرَ على معنىً للتّضامن الإنسانيّ، فَبدونِه لا يمكنُ لأيِّ مجتمعٍ أن يتماسكَ. في الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر ١٨٧٣، كتبَ تولستوي في مذكّراته «الحبّ مُزعج». بلى، النشاطيّة السياسيّةُ شكلٌ من أشكال الحبّ، وهي تحمل عنصراً متفجّراً قد يقود إلى انتفاضات عارمة. ولكنْ ما الذي سيحصلُ إذا نحن لم أغفلنا عن خوض تلك المغامرات، وإن كنّا مصمِّمين على الحفاظ على الأمور كما هي عليه، أو نتظاهر بالحفاظ عليها؟ الجواب بسيط: إذا امتنعنا عن دفع الثمنِ الضروريّ لتغيير العالم، سوف يتغيّر العالمُ على طريقته، سوف يتغيّرُ رغم كلّ شيء، ويتفلّتُ عن الإمكانيّة التي نملكُها لنقودَه في دروبٍ نحسَبُها مفيدةً، وينتهي الأمر بأنْ يصيرَ الثمنُ باهظاً وتَفوتَ الفرصة! وإنْ شئنا تصويرَ الأمور على أسوأ أشكالها، نقول إنّ هذه المشكلةَ كونيّة.
والآن، يمكننا أنْ نتأمّل في الحبّ كما يتجسّدُ عموماً، بالطريقة التي يمارسُها البشرُ منذ أنْ كانت البشريّة، مع أنّ الحبَّ في أيّامنا هذه يُساءُ فَهمُه إلى أبعد حدّ وقد جرى تَسليعُه كليّاً بمختلف أشكالِه.
لكنّ الحبّ بمعناهُ الأكثرِ أصالةً موجود. وقد يبدأ منذ الطفولةِ: في سنّ التاسعةِ أو العاشرة، يتعلّقُ الطفلُ بزميلٍ أو زميلةٍ في المدرسة، أو بطفلٍ آخرَ يلفتُ انتباهَه ويستحوذُ على قلبه. ثمّ يبدأُ الواحدُ بالإحساس بالفارق بين الرفقة والحبّ.
يبدأ الحبّ بملاحظةِ ثنيةِ خصر، طُولِ حاجِب، ولادةِ بَسمة. «حصل!». أن يستحوذَ وجودُ كائنٍ آخرَ على انتباهِك، على مشاعرك، وينمو هذا الشعور، يصير رغبة في تكرار التجربة. يصيرُ مساراً ورحلة. ثمّ تستولى المخيّلةُ على هذا الواقع وتَشرعُ في بناء تخييلات، أحلامٍ ومشاريع... إنّ الحبّ يخلقُ بذاته الحاجةَ إليه، ولدى بعض الناس تجد أنّه يلفُّ حياتَك بكاملها. يصيرُ ذلك الصوتُ الذي يقولُ لك في الليل «إنّي أحبّك» فيختلّ منك التوازنُ. في النهاية، الحبّ هو ذاك الذي يمسُّ مناطقَ تجعلك تسائلُ الكونَ كلَّه، وهذا ما يسيطر على أفكارك، ويتحوّلُ إلى إدمانٍ حقيقيّ. إذذاك، في الأحوال المأسويّة، هذا هو ما يقعُ في هوّة، مليئاً بتأوّهاتِ الوجع، حيث يفقدُ العشّاقُ كلَّ قدرة على التديّر وينعدم عندهم كلّ حِسٍّ بالواقع. إنّها اللحظاتُ حيث يستطيعُ شاعرٌ أن يقولَ فيها إنّ الحبّ يغيّر وجهةَ الزمَن.
ان تكون عاشقاً بتلك الطريقة حالة صعبة: أنت مقلقَل، تتقاذفُك الرياحُ وأنتَ تقاربُ الاختلالَ العقليَّ. وهذا ما يولّد بسهولةٍ شعوراً بالرعب يتحوّل إلى هاجِس. فتتسارعُ نبضاتُ قلبك، وتُشعُّ أنوارك كلُّها، فتستلقي قربَ جسدٍ آخرَ مستسلماً لهناءةٍ يائسة.
كيف يمكن تحمّلُ مثل هذه الحمّى؟ يصير الحبُّ دَفْقَ نارٍ يحلّ محلّ الدم في الشرايين. يترككَ مقطوعَ النفَس. فتجْمدَ، بلا حراكٍ، متناسياً الوقتَ. حتى إنّ إحساس المرء بجسمِه ذاتِه يختفي. يختفي الجسدُ من الذاكرة. فيتولّدُ إذّاك جمودٌ عائدٌ إلى تأهّبٍ كاملٍ للأحاسيس وقد باتتْ في حالةٍ من التحوّل. وإذا الرغبةُ نفسُها لا تلبَثُ أن تُهزم. والغريبُ جدّاً في الأمر أنّ هذه الحالةَ تشبه تجربةَ الموت.
مَن يستطعُ أنْ يحتملَ مثلَ هذا الانقلابِ لفترةٍ طويلة؟ حتى العاشقونَ ينتهون إلى الخوفِ من سعادتهم فيعملون على تدميرِها. والمجتمعُ نفسُه يعارضُ مثلَ هذا الحبّ ويقمعُه قدْر استطاعتِه. يرى المجتمعُ إلى الحبّ على أنّه يحملُ طاقةً على التخريب.
يشتغلُ الحبُّ دَوماً مثل هزّةٍ أرضيّة. هزّةٍ أرضيّةٍ لا تكتفي بوَقْعِها القويِّ على العاشقين وإنّما تتعدّاهُ للذين يشاهدونها. يصابُ هؤلاءِ الآخرونَ بالحسَد. تتملّكُهم غيرةٌ شديدة. فلا غرابةَ في أنْ تقعَ «جرائمُ شرفٍ» أو أنْ تُرتكبَ جرائمُ قَتْل أخرى بحقِّ النساءِ تتعلّقُ بالحبّ والجنس. الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ ذاتُها معاديةٌ بوضوحٍ لمبدأ اللذّة في الحياة الشخصيّة لرَعاياها، إذ تحصرُ الجنسَ بالتوالدِ فقط وتمجّدُ عذريّةَ مريم. وهذا مثالٌ بين امثلةٍ عديدة. لا مخرَج. للحبِّ ثمنٌ (مثله مثل أي تعبير انساني آخر). نحن حيواناتٌ مجتمعيّةٌ والمجتمعُ سوف يربضُ دوماً على حيواتنا.
الحقّ يقالُ إنّنا بلغْنا النقطةَ التي انفصلَ عندها الجنسُ عن الحبّ. السذّج الفزِعونَ من القصص الخرافيّة القابلةِ لأنْ تَقلبَ حياتهم رأساً على عقِبٍ وأنْ تثيرَ النزاعات، هؤلاءِ هم الذين يقعونَ في حبّ نجومِ السينما والشخصيّاتِ الروائيّةِ بسهولةٍ أكبر من حبّهم لشركائهم في الحياة - وهذا حينَ لا يقضونَ الأماسي كاملةً في قراءة المجلّات الرياضيّة ومشاهدة مباريات كرة القدم. إنّنا شديدو التعلّقِ بأهواءَ لا تتطلّبُ أيَّ تفسيرٍ مباشَر... «الحياة الحديثةُ» توفّرُ طرائقَ متعددةً لكي يتيهَ المرءُ في عالَمٍ فَقَدَ معناه.
إنّنا نرى إلى هذا على أنّه تحرّرٌ للجسد وقد بات يتمتّعُ باستقلاله الذّاتيّ واستعادَ حقوقَه. الجنسُ بما هو ملاعَبَةٌ، يجري تقديمُه على أنّه قمّةُ الحصافةِ والصحيحُ أنّ ذرّةً من الاستسهال لا تضرّ. على أنّ إنكار العواطفِ على المدى البعيد، يمكن أن يشجّع على العنف، وهذا ما يحصل. ألم تتحوّلْ صناعةُ السينما إلى عالَمٍ أفْلتَ فيه الخَيالُ من كلّ عقال، تحديداً لكي يؤلّفَ قصصَ خيالٍ علميٍّ أو قصصَ جرائم... ألم تصبحْ البورنوغرافيا صناعةً عابرةً للقوميّات؟
ولكنْ ما هو الحبّ؟ وعمَّ نقلعُ عندما نتخلّى عنه؟
في الليل وفي اكتشاف الحبّ
الحبُّ لا يوصَف. إنّه يُعاش. يمكن إنكارُه، لكنْ لا نلبَثُ أنْ نتعرّف عليه عندما يمتلّكنا، عندما يُخضعُ شيءٌ ما داخلَنا أنانا له. العاشقُ سجينٌ هو سجّانُه. الحبّ كنايةٌ عن حمّى غريبة. ويَحدُثُ أحياناً أنّ العاملَ الذي يثيرُ الحبّ ليس بالضرورة بشريّاً.
غادرتُ بيروتَ إلى باريس لدراسة الفلسفة. ومثل العديد من الفتيات، عاشرتُ عدّة عشاق... ولكنْ في جيلنا كان العاشقُ شخصاً نسيرُ برفقتِه في الطرقات بلا نهاية، نراقصُه، نحادثُه عن الحبّ... لم تكن لنا حياةٌ جنسيّة، فقط بعضُ اللقاءات الجنسيّة الغامضة، يمكن وصفُها بأنّها لقاءاتٌ «مناخيّة»، حالةٌ من العافية، والمفاخرة بأنّنا نجذب إلينا العديدَ من الصبيان، والعشقُ فوق ذلك طبعاً، رعشةٌ في الجسد ورغبةٌ لم نكن نسمّيها رغبة... وكنّا نعتقدُ أنّنا ذوو ثقافةٍ راقيةٍ بما فيه الكفاية لأنّنا كنّا أوّلُ جيلٍ من الصبايا سُمِحَ لهنّ بالاختلاط بالصِّبية، ولو ضمن حدود. كانت تلك مغامرةً عظيمة!
لم يكن لي أصدقاءٌ مقرّبون في الأيّام الأولى من إقامتي في باريس. وهذا مفهومٌ. يتطلّبُ الأمرُ بعض الوقت ليتمكّن الطلّابُ الأجانبُ من عَقْد صلاتٍ مستدامةٍ مع زملائهم. كنتُ أشعر بوحدةٍ عميقة، لكنّ اكتشاف المدينة صار عندي مهنةّ أخّاذة، كانت المدينة تأسرُني وكنتُ سعيدة.
كنتُ أحبّ الليلَ ولا أزال. الليلُ مكوّنٌ من مكوّناتِ الحبّ، مثله مثل الضباب. الليل يحرّر المدى، ويسمح للنضارة بأن تخترقَه. إنّ سحرَه ينعشُ الجسدَ، ويستجلي لنا لغزَ الحياة أو الوجود. بنجومٍ ومجرّاتٍ أو بدون نجوم ومجرّات، تصير السماءُ مدىً خاصّاً - مدىً خاصّاً للخيال. وهي لحظاتٌ نصلُ فيها إلى كلّ ما هو قائمٌ بيننا وبين القمر.
في أحد تلك الأيّام المنعشة والمنوّرة، ذات عصريّةٍ أشبهِ بلَون الفضّة، كما في لوحةٍ أو محفورة، ذهبتُ إلى متحف اللوفر.
دخلتُ بتؤدةٍ في ذاك المعبد، لأوّل مرّة، ببراءة. بعد خطواتٍ قليلة، توقّفتُ أمام «انتصار ساموثراس» - «النصر المجنّح». جمدْتُ في مكاني مبهورةً. هذا شخصٌ يتأهّبُ للإقلاعِ مثل طائرة في حُلم صامِت. إنّه أفضلُ من طائرة. إنّه حضارةٌ تقلعُ أمامَ ناظري، دون أن تغادرَ الأرض، حضارة امّحى منها كلُّ مَعْلمٍ عدا التعبير البدئيّ.
ثمّ التفتُّ فرأيتُ «ڤينوس دِ ميلو»: تمثالاً من المرمر الأبيض، منتصباً أو حانياً حسب موقع النظر إليه، يبدو أكبرَ من قامةِ شخصٍ حقيقيّ. كم استغرقتُ من وقتٍ وأنا أتأمّلها؟ أكيد أنّي لم أُعِر الوقتّ أيّ اهتمام. كنتُ بمفردي. كنّا وحدَنا أنا وهي. كانت عيناي تتنقّلان على جسدِها، الذي هو بين لحمٍ وحجَر، تتوقّف هنا وهناك، مكتشفةً انحناءاتٍ مُعَدّة للجذْب والصدّ في آن معاً، متسائلةً عن لغزِ ذلك الحضور: إنّها حيّة ومع ذلك لا تزال مصنوعةً من مرمر، ونحن ممنوعونَ من لمَسها ولكنّنا نحلم بذلك.
لقد هزّني النحّاتُ الإغريقيُّ الذي استولَدَ أشكالَ تلك الآلهة، قوامَها وحياتَها. استيقظتْ حواسي بكاملها فجأةً. فقدتُ صوابيَ أمام هذا الجمال الجليديّ الخطير. صار المشهدُ بمثابة طقسِ عبورٍ بالنسبة إليّ. انفرج فيّ شقّ. أمضيتُ ليلةَ الرؤيةِ تلك معها «هي»، في أعمق وأغنى وحدةٍ خبرتُها في حياتي. كان فصلَ الشتاء، لكنّني أمضيتُ الليلَ وأنا أتصبّبُ عرَقاً. أغمضْتُ عينيّ ودسستُ وجهيَ في المخدّة. كنتُ أحترقُ وَلَهاً. مارستُ الحبَ بمفردي ومخيّلتي مشتعلةٌ.
كانت تجارُبي اللاحقةُ مختلفةً بالتأكيد... وجدتني مقذوفةً في ما يسمّيه الناسُ «العالَمَ الحقيقي». لكنّ التجربةَ الأولى بقيَتْ مثلَ علامةِ استفهام، مثل صورةٍ يتكرّر ظهورُها، مثل رؤيا: ظلّتْ قدرةُ الفنّ التي تتضمّنُها تلك «الحادثةُ» مصدرَ اضطرابٍ دائم. بل صارتْ ذكرى ما حدَثَ تلك الليلةَ بمثابة تأمّلٍ في طبيعة الحبّ. تأمّل لم يفعل غيرَ تعميقِ لغز الحبّ.
قبل أن ينتحرَ ماياكوفسكي تركَ هذه الملاحظةَ المُبتسَرة: «لِيلِي، أحبّيني!». نسيَ الثورةَ والشِعر. كان الحبُ المستحيل (حياتُه الفاشلة) يحدّق فيه بشراسةٍ لا تلين.
صحيحٌ أنّ الحبَّ يولدُ من الحياة وأنّ خسارةَ الواحدِ منهما تجعلُ الآخرَ عبَثاً لا غير. ولكنْ لمّا كان معظمُ الناس لا يتجرّأُ على قبول عواقب أهوائهم، يحوّلون إلى أساطير الأهواءَ التي يعيشونها إلى نهاياتها، مهما كان الثمن، أو يجسّدونها في شخصيّات تاريخيّةٍ أو مخلوقات رومنطيقيّة. ألسْنا نقعُ في غرام آنّا كارنينا ونذرفُ دموعاً حقيقيّةً ونحن نقرأ قصّتها؟ ألسْنا نشاهدُ القطارَ الذي رمَتْ بنفسها تحتَه بعيون الخيال؟ ألسْنا نؤيّد فِعْلتَها، بالسّرّ، ونحن نقرأ قصّتَها في بيتِنا الدافئِ بعدما دسسْنا الأطفالَ في أسرّتهم؟ وهذا ينطبقُ على الشعراء أيضاً: نقرأ ونعيدُ قراءة قصّةِ مجنون ليلى تائهاً في الصحراء العربيّة لأنّه لم تسنح له الفرصة لأن يكون بقرب ليلى، هائماً على وجهه حدّ الانهيار، أو يغمرنا الأسى على رامبو من جُبن البائس ڤيرلين الذي يتحدّثُ إلى الشاعر الذي عشِقَه عن الأمّ والزوجةِ والكنيسة، في رسالته الوداعيّة!
عندما نعشقُ ننقلبُ إلى طَير: نمدّ عنقَنا وننصتُ إلى أغنيةٍ لم نسمعْها. ينكتمُ منّا الصوتُ. لكنّ كثيرين هم الذين ليسوا مستعدّين للمخاطرة بحيواتهم من أجل تلك اللحظة. بل ليسوا مستعدّين للمجازفة بما هو أقلُّ من ذلك: أنْ يتزحزحوا من أمكنتهم فقط! إنّهم خائفون، يؤْثرون المحافظةَ على تَفاهَتهم. يمكننا أن نفهمهم: الحبّ بكلّ اشكاله هو أعظمُ ما نواجِه على الإطلاق لكنّه أخطرُ ما نواجه أيضاً، والأقلّ توقّعاً، والأكثرُ امتلاءً بالجنون. ومع ذلك، فالحبّ هو الخَلاصُ الوحيد الذي أعرفُه.

إضافة تعليق جديد
تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.